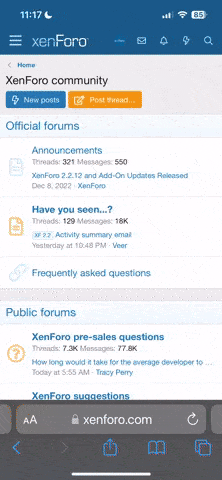- إنضم
- 17/9/22
- المشاركات
- 6,739
- التفاعلات
- 15,009
في وقت ما في ستينيات القرن العشرين، كان يُشار إلى باكستان على أنها "الحليف الأكثر حلفاءً" لأميركا بسبب عضويتها في العديد من المنظمات الدفاعية المتعددة الأطراف، مثل سياتو وسينتو، بقيادة الولايات المتحدة. ولا تزال واشنطن تعتبرها من الناحية الفنية "حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو". كان هذا شرفا مُنح في عام 2004، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دعم الرئيس برويز مشرف للغزو الأميركي لأفغانستان بعد الهجمات الإرهابية في عام 2001. ولكن المرء لا يستطيع أن يخمن هذه الحقيقة من خلال سماع أو قراءة خطب الرئيس ترامب اللاذعة الأخيرة ضد باكستان.
وفي أول تغريدة له في يوم رأس السنة الجديدة، خص ترامب باكستان بالانتقادات اللاذعة. وأعلن أن "الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ولم يقدموا لنا سوى الأكاذيب والخداع، معتقدين أن قادتنا حمقى. إنهم يوفرون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، دون مساعدة تذكر. لا أكثر!"
وجاء تحذير ترامب بعد وقت قصير من تسريب إدارته للأخبار التي تفيد بأنها تخطط لحجب 255 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإسلام آباد. وأعقب هذه التغريدة بعد أيام قليلة الإعلان عن تجميد واشنطن جميع المساعدات الأمنية تقريبًا لباكستان، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويًا. وكانت الولايات المتحدة تطلق مثل هذه التهديدات بشكل دوري، وخاصة في يوليو/تموز 2011، بعد شهرين من اغتيال أسامة بن لادن، دون أن تنجح في تغيير سياسة باكستان تجاه أفغانستان ودعمها للجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية. وبغض النظر عن تصحيحات المسار البسيطة، فقد استمرت إسلام أباد في ممارسة أعمالها كالمعتاد، وفي نهاية المطاف اضطرت واشنطن إلى التصالح مع الثوابت الجديدة في سياسات باكستان الخارجية والأمنية.
السبب الرئيسي وراء عدم قدرة الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إجبار باكستان على تغيير اتجاه سياستها الخارجية، على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات، هو أن الأهداف الرئيسية للسياسات الخارجية للبلدين تختلف إلى حد كبير عن بعضها البعض، وغالباً ما تكون الأهداف الرئيسية للسياسات الخارجية للبلدين مختلفة إلى حد كبير عن بعضها البعض. تتعارض مع بعضها البعض. حتى نهاية الثمانينيات، كان الهدف الأمريكي الرئيسي في جنوب وجنوب غرب آسيا هو مواجهة ما اعتبرته اندفاع الاتحاد السوفييتي نحو المياه الدافئة في المحيط الهندي. تم تشكيل التحالفات بهدف احتواء الاتحاد السوفييتي، وإذا أمكن، إخراجه من البلدان التي اكتسب فيها نفوذه.
في أوائل خمسينيات القرن العشرين، كان وزير الخارجية جون فوستر دالاس ينظر إلى باكستان باعتبارها أصلاً عسكريًا وسياسيًا رئيسيًا يمكن أن يساهم في احتواء الاتحاد السوفييتي، خاصة وأن جارتها الأكبر الهند رفضت قبول هذا الدور. ونتيجة لذلك، دخلت الولايات المتحدة في اتفاق المساعدة الدفاعية المتبادلة مع باكستان في عام 1954، وانضمت الأخيرة إلى التحالفات المتعددة الأطراف المناهضة للشيوعية المذكورة أعلاه.
وكانت باكستان على استعداد للعب الدور الذي كلفته به واشنطن، طالما أنه يخدم هدفها الرئيسي: "استعارة القوة" من الخارج من أجل تحييد تفوق الهند المتأصل في القوة في جنوب آسيا. أصبحت هذه الحاجة حادة بشكل خاص بالنسبة لباكستان بعد حرب كشمير الأولى في الفترة 1947-1948، والتي تركت الجزء الأكبر من الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة الهندية. بالنسبة لباكستان، كانت معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت بمثابة خدعة لجذب المساعدات العسكرية، في شكل أسلحة متطورة بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة.
وجاء أول مؤشر رئيسي لهدف باكستان الحقيقي في أوائل الستينيات، عندما تزامنت مع الحرب الصينية الهندية عام 1962، عندما اتجهت نحو الصين، الخصم الرئيسي لأميركا في آسيا آنذاك، طلباً للمساعدة في تحييد الهند. وأصبح من الواضح أن الصين وباكستان تشتركان في هدف استراتيجي رئيسي تجاه الهند، وبالتالي طورت باكستان علاقة وثيقة مع بكين، على الرغم من الانتكاسة المؤقتة التي جلبتها للعلاقات مع واشنطن.
تبنت الهند سياسة عدم الانحياز بعد فترة وجيزة من الاستقلال في عام 1947، على الرغم من ميلها المتعمد نحو الاتحاد السوفييتي بدءًا من عام 1954، عندما أنشأت الولايات المتحدة علاقة تحالف مع باكستان. وقد بردت علاقات إسلام أباد مع واشنطن في ستينيات القرن الماضي، لكنها عادت إلى الحياة من جديد إلى حد ما في عام 1971، عندما عجّلت باكستان بالتقارب بين الولايات المتحدة والصين من خلال تسهيل الزيارة السرية التي قام بها هنري كيسنجر إلى بكين. وفي المقابل، دعمت الولايات المتحدة باكستان في حربها مع الهند في ديسمبر/كانون الأول 1971، وذلك جزئياً لتثبت للصين أن هناك مجالات تتداخل فيها مصالح واشنطن مع مصالح بكين.
ولكن لم تتجدد علاقات أميركا مع باكستان إلا بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان في الفترة 1979-1980، عندما أصبح الرئيس ضياء الحق القناة الرئيسية لنقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى المتمردين الذين يقاتلون النظام الذي يدعمه السوفييت في كابول. ولم يأت ذلك بدون ثمن: فقد سُمح لباكستان بالاحتفاظ بجزء كبير من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أفغانستان، لتعزيز قواتها العسكرية قوتها في مواجهة الهند.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمدت الإدارات الأميركية المتعاقبة غض الطرف عن برنامج الأسلحة النووية السري في باكستان، والذي بدأ يؤتي ثماره في وقت ما في الثمانينيات، على الرغم من أن إسلام أباد لم تختبر أسلحة نووية حتى عام 1998، في أعقاب التجارب النووية التي أجرتها الهند. وكان من الواضح أنه في حين ساعدت باكستان الولايات المتحدة في تحويل أفغانستان إلى فيتنام الاتحاد السوفييتي، فقد اغتنمت باكستان الفرصة لتعزيز قدراتها التقليدية، فضلاً عن بناء ترسانة نووية سرية لمواجهة تفوق الهند التقليدي وقدرتها النووية المفترضة في جنوب آسيا.
طوال النصف الأخير من القرن العشرين، تعاونت الولايات المتحدة وباكستان في القضايا الاستراتيجية كلما كان ذلك مناسباً لهما، ولكن أهدافهما الرئيسية تباينت بشكل أساسي. كانت الولايات المتحدة تركز اهتمامها على تنافسها مع الاتحاد السوفييتي في سياق الحرب الباردة. وكانت باكستان مهووسة بتفوق الهند في القوة، وهو الأمر الذي جعلته هزيمة عام 1971 وتأسيس بنجلاديش أكثر إثارة للحنق. وكانت باكستان تعتقد أن أمنها لا يمكن ضمانه إلا من خلال التكافؤ العسكري التقليدي مع الهند، وإذا فشل ذلك، فمن خلال القدرة النووية على توجيه ضربة ثانية من شأنها أن تردع نيودلهي عن شن هجوم تقليدي، سواء حول كشمير أو أي نزاع آخر.
وكان من بين النتائج الثانوية لبحث باكستان عن الأمن ضد الهند سعيها إلى تشكيل حكومة صديقة في أفغانستان قادرة على المساعدة في تزويدها بالدفاع في حالة نشوب حرب في المستقبل. وكانت أفغانستان تقليدياً جارة مزعجة لباكستان منذ استقلال الأخيرة لأن كابول لم تعترف بشرعية خط دوراند الذي فرضته بريطانيا، والذي يشكل الحدود بين البلدين. فضلاً عن ذلك فإن الكراهية المشتركة تجاه باكستان كانت سبباً في دفع الهند وأفغانستان إلى الدخول في شبه تحالف.
لكن كل هذا تغير مع الغزو السوفييتي لأفغانستان، والذي برزت في أعقابه باكستان باعتبارها الداعم الأساسي لاستقلال أفغانستان، خاصة وأن الهند اختارت أن تظل متناقضة. والواقع أن نيودلهي أيدت الموقف السوفييتي القائل بأن التدخل الأميركي والباكستاني في أفغانستان كان السبب الجذري للمتاعب في ذلك البلد.
للمرة الأولى في تاريخها، حصلت باكستان على الفرصة لتولي حكومة صديقة السلطة في أفغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفييتي في عام 1989. وقد حققت إسلام أباد هذه الفرصة بتنصيب نظام طالبان المدعوم من باكستان في عام 1994. ولكن هذا لم يستمر إلا حتى عام 1994. 2001. في ذلك العام، اضطرت باكستان إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ضد طالبان لأن إدارة بوش، بحسب مشرف نفسه، هددت بقصف باكستان وإدخالها إلى العصر الحجري إذا لم تتعاون الأخيرة مع الحرب الأمريكية ضد تنظيم القاعدة والقاعدة. طالبان في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تتخل باكستان أبدًا تمامًا عن تطلعها إلى وجود نظام صديق في أفغانستان - أو على الأقل نظام لا يشارك في تعاون استراتيجي واقتصادي مع الهند، مما يهدد المصالح الباكستانية. وإذا فشل هذا الأمر، فإن باكستان كانت تود لو تشهد أفغانستان حالة من عدم الاستقرار الدائم، وتفتقر إلى القدرة على العمل كوكيل استراتيجي للهند أو الولايات المتحدة. ويشكل دعم إسلام أباد لفصائل طالبان الأفغانية وغيرها من الجماعات، مثل شبكة حقاني، التي تستهدف القوات الأميركية في أفغانستان، جزءا من هذه الحسابات الاستراتيجية.
وهذا هو ما أدخل إسلام أباد في مواجهة مباشرة مع واشنطن، التي لا تزال تنزف منذ سبعة عشر عاماً من تدخلها في أفغانستان. وكما يظهر تهديد الرئيس ترامب، فإن واشنطن تحمل باكستان المسؤولية في المقام الأول عن الفوضى المستمرة في أفغانستان، وكذلك عن تسهيل الهجمات على أهداف أمريكية من قبل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة. ولكن بالنسبة لباكستان فإن دعم طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة يشكل استراتيجية عقلانية إلى حد كبير، في ظل غياب نظام موالي لباكستان في كابول راغب وقادر على الإبقاء على النفوذ الهندي عند الحد الأدنى.
وبالتالي فإن تدهور العلاقات الأميركية مع باكستان يشكل انعكاساً للتناقضات المتأصلة في العلاقة منذ أن بدأت في الخمسينيات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا إلى انقطاع كامل. وتحتاج الولايات المتحدة إلى باكستان باعتبارها طريق إمداد رئيسي لقواتها المنخرطة في أفغانستان. ويعد طريق الإمداد عبر آسيا الوسطى بديلاً سيئًا للمرافق الموجودة في باكستان وعبرها. وتستمر باكستان، على الرغم من التبجح العرضي من جانب قيادتها، في الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على الأسلحة المتقدمة لمنع ميزان القوى التقليدية من الميل بشكل أكبر لصالح الهند.
وتروج كل من إسلام أباد وبكين لخطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني باعتبارها شريان حياة اقتصادي جديد من شأنه، من بين أمور أخرى، أن يجعل اعتماد باكستان الاقتصادي على الولايات المتحدة زائداً عن الحاجة. ووفقاً لـ سي. كريستين فير، وهو مراقب ذكي للمشهد الباكستاني، فإن "المسؤولين الباكستانيين والصينيين يتباهون بأن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني سيساعد في معالجة مشكلة توليد الكهرباء في باكستان، وتعزيز الطرق والسكك الحديدية.
ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة”. لكنها خلصت إلى أنه «من غير المرجح أن تتحقق هذه الفوائد. ويميل المشروع أكثر إلى ترك باكستان مثقلة بالديون غير القابلة للسداد مع زيادة كشف الشقوق في أمنها الداخلي. ولذلك، يتعين على باكستان أن تستمر في الاعتماد على الضخ الدوري للمساعدات الاقتصادية الأميركية لتظل واقفة على قدميها.
وطالما لا توجد طريقة بسيطة لحل هذه الدائرة من التوقعات الاستراتيجية المتناقضة، يبدو أن واشنطن وإسلام آباد محكوم عليهما بالعيش معاً لسنوات، إن لم يكن لعقود، في ظل التناقضات الداخلية المتراكمة في علاقتهما. ويحتاج كل منهما إلى الآخر لتحقيق أهداف فورية مهمة، حتى لو كانت استراتيجياتهما الكبرى المتعلقة بالمنطقة تتباين بشكل كبير.